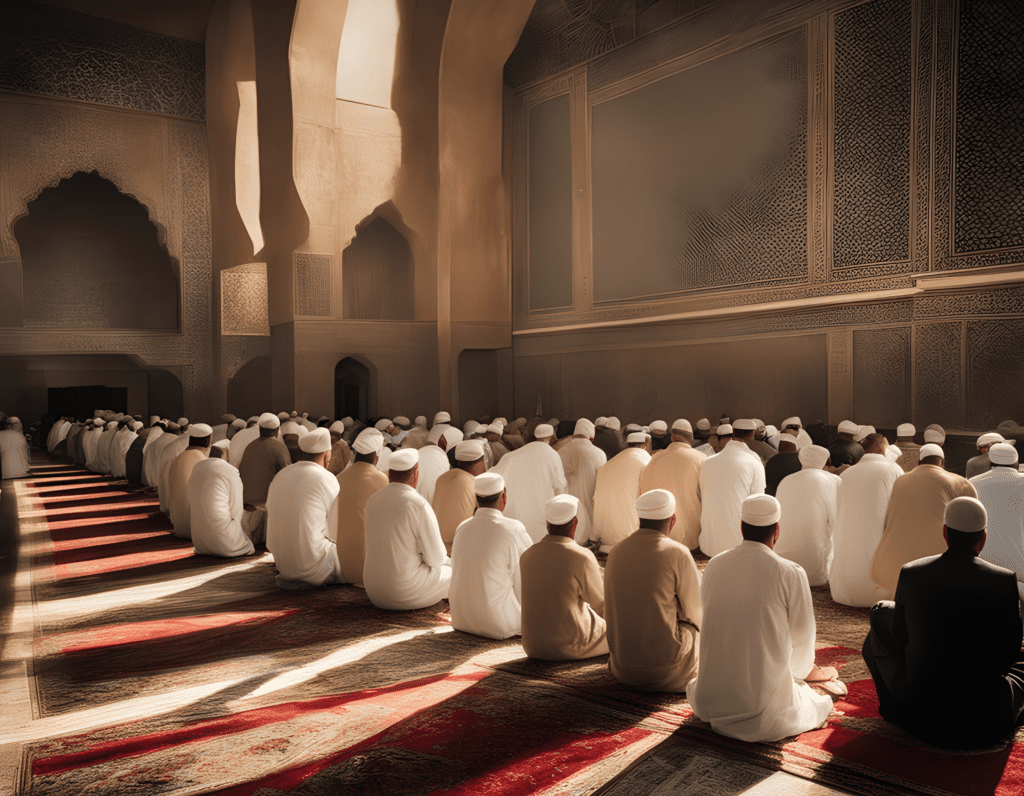الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن صلاة العيدين هي سنة مؤكدة على المسلمين في عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي من أعظم الشعائر التي تبرز عظمة الدين الإسلامي. تُعد صلاة العيدين من أخص خصائص العيد، فهي صلاة جماعية تُؤدى بعد شروق الشمس وقبل زوالها، وتتميز بتكبيرات خاصة وطريقة أداء مميزة عن باقي الصلوات. إن تعلم كيفية صلاة العيدين أمر ضروري لكل مسلم، حتى يؤديها على الوجه الصحيح وفقًا للسنة النبوية. في هذا المقال، سنتناول كيفية صلاة العيدين خطوة بخطوة، مع الاستناد إلى الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، لنوضح لك الطريقة الصحيحة لأداء هذه الشعيرة المباركة.

أهمية صلاة العيدين في الإسلام
صلاة العيدين من الشعائر التي ثبتت في الكتاب والسنة، حيث كانت سنة مؤكدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على أهميتها. وقد ثبت في حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “صلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ وصلاةُ الجمعةِ رَكعتانِ والفطرُ والأضحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ” الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 879 | خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1440)، وابن ماجه (1064) واللفظ له، وأحمد (257).
وبذلك، تبرز صلاة العيدين كأحد الشعائر الكبرى التي يحرص المسلمون على إحيائها في كل عام. فالصَّلاةُ عبادة توقيفيَّة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أداء الصلوات بما يتوافق مع السنة. في هذا السياق، جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ‘الفِطْرُ والأضْحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصْرٍ، على لِسانٍ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم’. يشير الحديث إلى أن صلاة العيدين، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، تؤدى ركعتين، وهي صلاة تامة وغير قاصرة، حيث لا يتعين فيها القصر كما في بعض الصلوات الأخرى. بذلك، تكتمل الصلاة في هذه الأيام المباركة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد الحديث على أن الصلاة في هذه الأوقات هي عبادة مكتملة الأجر، وليس فيها أي نقص. وبذلك، تظل كيفية صلاة العيدين في العيدين من العبادات التي تكتمل بكل تفاصيلها كما ورد في السنة.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: “وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ“ (البينة: 5). هذه الآية توضح أهمية إقامة الصلاة بشكل عام، بما فيها صلاة العيدين.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: “أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يُكبِّرُ في الفِطرِ الأولى سبعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يُكبِّرُ ثمَّ يقومُ فيُكبِّرُ أربعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يرْكعُ” الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1152 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح، دون قوله: “أربعا” والصواب “خمسا” التخريج : أخرجه أبو داود (1152)، وعبد الرزاق (5677)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2169) واللفظ لهم، وابن ماجه (1278) بنحوه.
كيفية صلاة العيدين
صلاة العيدين هي ركعتان تُؤدى في جماعة، وتُصلى بعد شروق الشمس وقبل زوالها. يجب على المسلم أن يتأكد من أن الوقت قد دخل قبل أداء الصلاة. كما يُؤدى في المصلى إن أمكن ذلك، وفي حال تعذر فإمكان الصلاة في المسجد.
“أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي في الأضْحَى والفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.” الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 957.
صَلاةُ العِيدِ لها واجباتٌ وسُننٌ وآدابٌ حرَصَ عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ونقلها لنا صحابته الكرام رضِي الله عنهم. وفي هذا الحديث، يُخبرنا ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ هَدْيَ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين كان أن تُؤدى الخُطبة بعد الصلاة، على عكس صلاة الجمعة التي تكون فيها الخُطبة قبل الصلاة. كما أن الخُطبة في العيدين تتكون من خطبتين، تمامًا مثل خطبة الجمعة.
وقد شُرعت الخُطبة في الجمعة والأعياد والمناسبات لحِكم عديدة، منها تعليم الناس أمور دينهم ودنياهم. وعندما يصعد الإمام المنبر، يكون هدفه تعليم الناس وإفهامهم، خاصة فيما يتعلق بالمناسبات الشرعية التي تصادف تلك الخطبة. كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال: “أن أول شيء يبدأ به هو الصلاة، ثم ينصرف الإمام فيقابل الناس وهم جالسون على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم.
“أنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَومَ الأضْحَى مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ نَهَاكُمْ عن صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ؛ أمَّا أحَدُهُما فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، وأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِن نُسُكِكُمْ. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مع عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَكانَ ذلكَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ هذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمع لَكُمْ فيه عِيدَانِ، فمَن أحَبَّ أنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِن أهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَرْجِعَ فقَدْ أذِنْتُ له. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مع عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَاكُمْ أنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.” الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5571.
“خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ فِطْرٍ أوْ أضْحَى فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ.” الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 975.
“كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شَيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ، فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أوْ يَأْمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قالَ أبو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ علَى ذلكَ حتَّى خَرَجْتُ مع مَرْوَانَ – وهو أمِيرُ المَدِينَةِ – في أضْحًى أوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أتَيْنَا المُصَلَّى إذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلتُ له: غَيَّرْتُمْ واللَّهِ، فَقالَ أبَا سَعِيدٍ: قدْ ذَهَبَ ما تَعْلَمُ، فَقُلتُ: ما أعْلَمُ واللَّهِ خَيْرٌ ممَّا لا أعْلَمُ، فَقالَ: إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.” الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 956.
وهكذا، تتسم كيفية صلاة العيدين بخصوصية وتفاصيل دقيقة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تضم ركعتين وخطبتين، ويحرص المسلم على أدائها وفق السنة النبوية.
كيفية صلاة العيدين
- التكبير: في الركعة الأولى يُكبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم يتبعها بتكبيرات، فتكون سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية تُضاف خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
- قراءة السور: بعد التكبيرات في الركعة الأولى، يقرأ المصلي الفاتحة ثم سورة “الأعلى” أو “ق”، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم سورة “الغاشية” أو “القمر”.
- الخطبة بعد الصلاة: بعد أداء الصلاة، يقيم الإمام خطبته، ويحث الناس على الاستغفار والتوبة، ويذكّرهم بمكارم الأخلاق وأحكام العيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: “كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شَيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ، فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أوْ يَأْمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.” الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 956.
حكم صلاة العيد
وهي ليست فرضًا على المسلمين ولكن من الأفضل أن يؤديها المسلم في المصلى مع الجماعة. ووفقًا لما ورد عن الصحابة، كانوا حريصين على أداء صلاة العيدين في جماعة، حيث لا يتركها إلا من يعجز أو يمر بظروف معينة. وفيما يخص حكم صلاة العيدين، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال رئيسية:
- صلاة العيدين هي سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية، قال الشيرازي: صلاة العيد سنة.انتهى. وقال في التاج والإكليل: صلاة العيد سنة مؤكدة.انتهى. ودليلهم على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأعرابي – وكان قد ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس – فقال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.
- أن صلاة العيد فرض كفاية، وإليه ذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب.انتهى. ودليلهم على ذلك: عموم قول الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [سورة الكوثر: 2]. ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة.
- أما القول الثالث والاضعف, أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا عند الحنفية، قال الكاساني : (والصحيح أنها واجبة، وهو قول أصحابنا.) واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرة، وأنه لا يصلى التطوع بجماعة – ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين، فإنها تؤدى بجماعة – فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع كما استثنى التراويح وصلاة الخسوف.
والراجح: هو مذهب الجمهور، وهو القول الأول.
وأما من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فقد اختلف أهل العلم هل يقضيها، أم لا؟ والراجح: أنه يسن له قضاؤها على صفتها، وقد ذكر النووي مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال: ( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إذَا فَاتَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ، قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا أَبَدًا, وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ, وَحَكَى الْعَبْدَرِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ وَدَاوُد أَنَّهَا لَا تُقْضَى, وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تُقْضَى صَلَاةُ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي, وَالْأَضْحَى فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: مَذْهَبُهُ كَمَذْهَبِهِمَا, وَإِذَا صَلَّاهَا مَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ, وَعَنْهُ رِوَايَةٌ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ, وَإِنْ شَاءَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ, وَبِهِ جَزَمَ الْخِرَقِيُّ، وَالثَّالِثَةُ: مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ, وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: رَكْعَتَيْنِ بِلَا جَهْرٍ وَلَا تَكْبِيرَاتٍ زَوَائِدَ، وَقَالَ إسْحَاقُ: إنْ صَلَّاهَا فِي الْمُصَلَّى فَكَصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا أَرْبَعًا.
ويسن للنساء حضور صلاة العيدين مع ضرورة مراعاة الحجاب الكامل والتستر، وتجنب التطيب. فقد ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: “أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى”. رواه البخاري في (الحيض) باب شهود الحائض العيدين برقم (324)، ومسلم في (العيدين) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين برقم (890).
وفي بعض ألفاظه: “فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه فقال ﷺ: لتلبسها أختها من جلبابها.” رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث أم عطية برقم (20269)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) باب ما جاء في خروج النساء في العيدين برقم (1307). لا شك أن هذا يشير إلى أهمية حضور النساء صلاة العيدين ليشتركن في الخير ودعوة المسلمين.
حكم أداء صلاة العيد في المنزل
يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم أداء صلاة العيدين في المنزل، خاصة في حالات مثل المرض أو العجز. في الواقع، يمكن أداء صلاة العيدين في المنزل إذا كان هناك عذر شرعي، ولكن يفضل أن تُؤدى الصلاة في المصلى مع الجماعة، إذا كان ذلك ممكنًا. وقد ذكر بعض العلماء أن أداء صلاة العيدين في المنزل جائز ولكنه لا يحمل نفس الأجر والثواب كإدائها في جماعة.
صلاة العيدين يوم الجمعة
اختَلَفَ أهلُ العِلمِ فيمَن صلَّى العيدَ؛ هل تسقُطُ عنه الجُمُعةُ إذا كانَا في يومٍ واحدٍ؛ على قولين: القولُ الأوَّل: أنَّها لا تَسقُطُ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وبه قال أكثرُ الفُقهاءِ ، واختارَه ابنُ المنذرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ عبدِ البَرِّ. أما الأدلَّة على ذلك: من القران: قال الله تعالى: “إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه” [الجُمُعة: 9]. مَنَ الآثارِ قال أبو عُبَيدٍ: ثمَّ شهدتُ مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبْل الخُطبةِ، ثم خطَبَ فقال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ هذا يومٌ قد اجتمَعَ لكم فيه عِيدانِ؛ فمَن أحبَّ أن يَنتظِرَ الجُمُعةَ مِن أهلِ العوالي فليَنتظرْ، ومَن أحبَّ أنْ يَرجِع فقدْ أَذِنْتُ له. والدليل الثالث: أنَّ الجُمُعةَ فرضٌ، والعيدَ تطوُّعٌ, والتطوُّعُ لا يُسقِطُ الفَرضَ. رابعًا: أنَّهما صلاتانِ واجبتانِ، فلمْ تَسقُطْ إحداهما بالأخرى، كالظهرِ مع العِيدِ.
القول الثاني: أنَّ وجوب حضور صلاة الجمعة يسقط عن من حضر صلاة العيدين، رغم أنَّه يجب على الإمام أن يُقيمها. هذا هو مذهب الحنابلة، وذهب إليه عدد من السلف، كما اختاره ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين، وقد نُقل عن عدد من الصحابة دون أن يعارضهم أحد. أما الأدلَّة على ذلك: من السُّنَّة عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: “مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ.” ثانيًا: أنَّ الجُمُعةَ إنَّما زادتْ عن الظُّهرِ بالخُطبة، وقد حصَل سماعُها في العيدِ، فأجزأَ عن سماعِها. ثالثًا: لأنَّ يومَ الجُمعةِ عيدٌ، ويومَ الفِطرِ والنَّحرِ عيدٌ، ومن شأنِ الشَّارعِ إذا اجتَمع عبادتانِ من جِنسٍ واحدٍ أدخَل إحداهما في الأخرى، كما يدخُلُ الوضوءُ في الغُسلِ، وأحَدُ الغُسلَينِ في الآخَرِ.
الفرق بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى
من المهم فهم الفرق بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في كيفية أدائهما وما يرتبط بهما من عبادات، حيث إن كل عيد له طابع خاص.
- عيد الفطر: يرتبط بنهاية شهر رمضان ويفضل فيه أداء زكاة الفطر قبل الصلاة.
- عيد الأضحى: يرتبط بحج المسلمين ويفضل فيه أداء قرباني (الذبح) بعد الصلاة.
شروط صلاة العيد
- وقت الصلاة: يبدأ وقت صلاة العيدين بعد شروق الشمس بقليل، ويستمر حتى قبل زوالها. ويُحدد العلماء الوقت بارتفاع الشمس قدر رمح.
- التكبيرات: تبدأ الصلاة بتكبير الإحرام ثم تليها سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية.
- الخطبة: يُسن أن تكون الخطبة بعد الصلاة، ويجب أن يُخصص الإمام جزءًا من خطبته لوعظ النساء وتوجيههن بما ينبغي فعله في العيد.
ما يفعله المسلم قبل الصلاة وفي صلاة العيد و يوم العيد
من السنة أن يحرص المسلم على بعض الأمور قبل الذهاب لأداء صلاة العيد، مثل:
- الاغتسال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاغتسال يوم العيد.
- أكل التمر: يُستحب تناول التمر قبل الخروج لصلاة العيد، وقد ثبت في الحديث الصحيح: “كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَغْدُو يَومَ الفِطْرِ حتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ. وقال مرجأ بن رجاء…: ويَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا.” الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 953 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال مرجأ بن رجاء… معلق] التخريج : أخرجه البيهقي (6221)، والبزار (7457) واللفظ لهما، والترمذي (543) بنحوه.
العبادات في يوم العيد
يوم العيد هو يوم عبادة وفرح، ويشمل العديد من الأعمال المستحبة:
- الصدقة: من السنن أن يعطي المسلم زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
- التهنئة: يُستحب للمسلمين تهنئة بعضهم البعض في هذا اليوم العظيم، ويقولون: “تقبل الله منا ومنكم”.
ما يجب تجنبه في صلاة العيد
ينبغي للمسلم أن يتجنب بعض الأمور أثناء صلاة العيد:
- التأخير عن الصلاة: ينبغي أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها المحدد.
- المبالغة في الخشوع: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بتركيز، دون مبالغة في التعبير عن الحزن أو الفرح بشكل غير لائق.
حكمة صلاة العيدين
صلاة العيدين ليست مجرد شعيرة فطرية، بل هي وسيلة للتقرب إلى الله، والتذكير بنعم الله على عباده، ودعوة للتعاون والتراحم بين المسلمين. من خلال هذه الصلاة، يُجدد المسلمون عهدهم مع الله ويشكرونه على ما أنعم به عليهم من نعم، سواء كان ذلك بنعمة الصيام أو بالقدرة على أداء مناسك الحج.
التكبيرات في أيام العيد
التكبيرات التي تقال في أيام العيد تُعد من أعظم الشعائر التي تميز هذا الوقت. يبدأ المسلم بالتكبير منذ مغرب ليلة العيد، ويستمر حتى صلاة العيد. هذه التكبيرات تُعد تعبيرًا عن احتفال المسلم بالعيد وتمجيد لله عز وجل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخرُجَ يَومَ العِيدِ حتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِن خِدْرِهَا، حتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بتَكْبيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلكَ اليَومِ وطُهْرَتَهُ.” الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 971 | التخريج : أخرجه البخاري (971)، ومسلم (890).
ومن الآثار:
1- عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يُكبِّرُ في قُبَّتِه بمنًى، فيَسمَعُه أهلُ المسجدِ، فيُكبِّرونَ، فيكبِّرُ أهلُ الأسواقِ، حتى تَرتجَّ مِنًى تكبيرًا)
2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُكبِّرُ بمنًى تلك الأيَّامَ، وخَلْفَ الصَّلواتِ، وعلى فِراشِه، وفي فُسطاطِه ومجلسِه، وممشاه تلك الأيَّامَ جميعًا)
3- وكانتْ ميمونةُ رَضِيَ اللهُ عنها: (تُكبِّر يومَ النَّحرِ)
التكبير في أيام التشريق
يبدأ التكبير المقيَّد من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أي اليوم الثالث عشر. وهذا هو مذهب الحنابلة، وذهب إليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقولٌ للشافعية، وقالت به طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر، والنووي، وابن تيمية، وابن حجر، وابن باز، وابن عثيمين، وحكي الإجماع على ذلك.
الأدلة:
أولًا: من الكتاب: قال الله تعالى: “وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ” [البقرة: 203]
وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فتعيَّن الذكر في جميعها.
ثانيًا: من الآثار:
- عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: “أنَّه كان يُكبِّر دُبرَ صلاةِ الغداةِ من يومِ عَرفةَ إلى صلاةِ العصرِ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ.”
- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: “أنَّه كان يُكبِّرُ من صلاةِ الفجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صَلاةِ العَصرِ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ.”
- عنِ الأَسودِ، قال: “كانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، يُكبِّر من صلاةِ الفَجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صلاةِ العصرِ من النَّحرِ؛ يقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ولله الحمدُ.”
- ن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: “أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ.”
ثالثًا: أنَّ ذلك عليه عمل الناس في الأمصار. رابعًا: أنَّ التكبير لتعظيم الوقت الذي شرع فيه المناسك، وأوله يوم عرفة؛ إذ فيه يُقام أعظم أركان الحج، وهو الوقوف. خامسًا: أنها أيام رمي؛ فكان التكبير في جميعها كيوم النحر.”
التهنئة في يوم العيد
من السنة المؤكدة أن يهنئ المسلمون بعضهم البعض في يوم العيد، فيقولون: “تقبل الله منا ومنكم”، “عيد مبارك”، “كل عام وأنتم بخير”. هذه التهاني تُعد تعبيرًا عن الفرح والسرور، وتُساهم في تقوية الروابط بين المسلمين.
تجنب المخالفات في العيد
من الأمور التي يجب تجنبها في يوم العيد:
- التبذير في الطعام والشراب: يجب على المسلم أن يتجنب الإسراف في الطعام والشراب، ويتحرى الاعتدال.
- الاختلاط المحرم: ينبغي للمسلم تجنب أي نوع من الاختلاط المحرم أو التجاوزات التي تضر بالروحانية العامة لهذا اليوم.
الخاتمة – كيفية صلاة العيدين: أهمية أداء الصلاة بشكل صحيح
صلاة العيدين من السنن المؤكدة التي يجب على المسلم أن يحرص على أدائها، فهي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى، والتذكير بنعمه ورحمته. ويجب على المسلم أن يؤدي صلاة العيدين على وجهها الصحيح، مع الالتزام بتكبيرات الصلاة والقراءة السنية في السور المقررة. كما ينبغي على المسلم الحرص على الخروج لأداء صلاة العيدين مع الجماعة، ومراعاة خطبة العيد وما تحتويه من وعظ وإرشاد، حيث تعد هذه الشعيرة فرصة لتجديد الإيمان وتعزيز الروابط بين المسلمين.
والله أعلم.